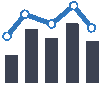| المستخلص: |
من نقد الشعر إلى تحليل الخطاب الشعري، ننتقل في الزمن من أواخر القرن التاسع عشر إلى ثمانينيات القرن العشرين. حقبتان تعكس كل منهما تصورا وفهما خاصا للأدب والدرس الأدبي. فإذا كان ((نقد الشعر)) ارتبط بالمنهج التاريخي ورديفه علم التحقيق، وكلاهما ساهم الاستشراق في الاشتغال بهما على أدبنا، فإن ((تحليل الخطاب)) اتصل باللسانيات وبالحقبة البنيوية. وإذا كان النقد اهتم أكثر بما هو خارج النص (حياة الشاعر –ثقافته- عصره) ليدخل من خلاله إلى القصيدة شارحا أبياتها، ملخصا موضوعاتها وقضاياها، منهيا نقده بفذلكات بلاغية حول أسلوب الشاعر ولغته وأوزان قصائده، فإن تحليل الخطاب انشغل أكثر بالخطاب من داخله، محاولا الكشف عن دلالاته انطلاقا مما تقدمه له القصيدة. في تحليل الخطاب الشعري نجد بصفة عامة نزوعا كبيرا نحو العلمية، وهو ما يقتضيه تحليل الخطاب بصفة عامة. وإذا كان توفيق بكار، وهو يدرك جيدا خصوصيات الشعريات، وموضوعها (الشعرية)، فإنه اختار واعيا أن يكون ناقدا، وله الحق في اختياره، ولا سيما وهو يعي جيدا الأصول والفروع، والعلاقات بين العلم والنقد، فبنى نقده على خلفية علمية. أما محمد مفتاح فكان منسجما مع منطلقاته وتصوراته التي عبر عنها في مختلف مؤلفاته، فبنى دراسته على أرضية علمية، وقدم لنا دراسة حول التوازي، انطلاقا من نص الشابي. فكان بذلك مؤسسا لتوجه جديد في الدرس الأدبي عامة، وفي التحليل الشعري بصفة خاصة. السؤال الذي نود أن نذيل به هذه الدراسة، للإجابة عن السؤال الذي صدرناه بها هو: لماذا لم يتطور تحليل الخطاب الشعري عندنا بالقياس، نسبيا، إلى تحليل الخطاب السردي؟ وجوابا على السؤال، أؤكد أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ذلك، ولعل أبرزها يكمن: أولا في كون تحليل الخطاب الشعري، حتى في أوربا، لم يعرف التطور الذي عرفه تحليل السرد. لكن هذا التفسير غير كاف، فالاجتهادات الشعرية الموجودة، بإمكانها أن توجه إلى الكشف والتطوير. لكن ضعف المواكبة، والقصور عن تمثل تلك النظريات حال دون الاستفادة منها. وثانيا، يكمن ذلك في كون المشتغلين بنقد الشعر، لم يتمثلوا البنيوية حق التمثل، فغاب عن مداركهم البعد العلمي لتحليل الخطاب الشعري، فظلوا يراوحون النقد، وإن كان الزعم على خلاف ذلك. وعندما نتابع الآن المؤلفات التي تتحدث عن الخطاب الشعري، نجدها أمشاجا من النظريات والتأويلات والانطباعات. ويبدو لي أن هذا هو الخلل الجوهري الذي أصاب العملية النقدية العربية، فحال ذلك دون ميلاد ((العلوم الأدبية)) في تراثنا الحديث. أما ثالثة الأثافي، وهي ليست لتبرير الوضع، ولكن لتعميق الفهم بـــــ ((الخلل الجوهري، وتكمن في أن تحليل الخطاب الأدبي العربي، وهو ينبني على ((أرضية لسانية))، لم يجد أمامه ((لسانيات عربية)) تمهد له السبيل وتيسر له المهاد للانطلاق. لقد قدمت اللسانيات ((نموذجا)) للتفكير في القضايا المتصلة بـــــــ ((اللغة)) وطورت فهم المسائل اللغوية، فاستندت عليها ((العلوم الأدبية)) وسارت على منوالها، إلى أن استقلت بنفسها عنها. كما أن العديد من اللسانيين انتقلوا إلى أحد العلوم الأدبية وساهموا فيها بكفاءة واقتدار. بالنسبة إلينا ما هو وضع ((اللسانيات)) عندنا؟ وما هو وضع العلوم الإنسانية؟ هل على المشتغل بالأدب، باعتباره علما، أن ينوب عن غيره من المشتغلين بالعلوم القريبة في مجالات اللغة والإنسان والنفس، وهل يتأتى له ذلك. إن الأمر يتعلق بسؤال ((العلمية)) في اشتغالنا الأكاديمي والجامعي، ولا يمكن لعلم أن يتطور دون أن يضطلع علم بدور الرائد؟ فهل على المشتغل بتحليل الشعر أو السرد أن ينتظر تبلور اللسانيات والاجتماعيات والإنسانيات وعلوم المعرفة في ثقافتنا ليبدأ عمله؟ أم أن عليه أن يغامر باقتحام ((المجال العلمي)) وهو يشتغل بالأدب، عسى أن يكون العلم الرائد مجرد سؤال للتفكير؟ ... لكن الأكيد هو أنه بدون انخراط الدرس الأدبي في مضمار ((العلم)) سنظل بعداء عن تحليل الخطاب وفهمه وتفسيره وتأويله.
|